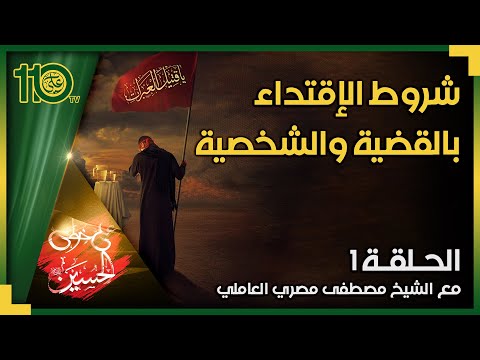بسم الله الرحمن الرحيم
المُقدِّم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزكى الصلاة وأتم التسليم على حبيب قلوبنا محمد الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى الرسل والأنبياء أجمعين.
أحبتي المشاهدين، في برنامجكم "على خُطى الحسين (عليه السلام)"، نهدف فيه إلى كشف ما يجب على الأمة الإسلامية وعلى كل إنسان حر من اتخاذ المواقف العقائدية والشرعية والأخلاقية الصحيحة تجاه ثورة كربلاء وقائدها العظيم الإمام الشهيد الحسين (عليه السلام)؛ حيث لزوم السير على خطاه للانتصار للحق، وفي الثبات، وفي الاستعداد للتضحية، وفي قصد وجه الله تعالى وحده.
أحبتي المشاهدين، في هذا البرنامج "على خُطى الحسين (عليه السلام)"، وفي هذه الحلقة الأولى، نتحدث في الجانب العقدي والشرعي عن ثورة الإمام الحسين (عليه السلام). معنا اليوم فضيلة الشيخ الأستاذ والباحث الإسلامي مصطفى المصري العاملي، فأهلاً ومرحبًا به.
فضيلة الشيخ: أهلاً وسهلاً بكم، حياكم الله، حفظكم وسدد خطاكم.
المُقدِّم: أحبتي المشاهدين، بعد وقفة قصيرة سنبدأ الحديث.
)وقفة قصيرة)
المُقدِّم: نرحب بكم مجددًا أعزائي المشاهدين. أهلاً ومرحبًا بكم فضيلة الشيخ مرة أخرى.
فضيلة الشيخ: أهلاً وسهلاً بكم، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم.
المُقدِّم: فضيلة الشيخ، نريد أن نبدأ جولة وفكرة جديدة عن الخُطى العقائدية والشرعية لثورة الإمام الحسين (عليه السلام).
فضيلة الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير رسله وأعز أنبيائه، سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا. سلام عليكم مشاهدينا الكرام، وسلام عليك أخي الكريم ورحمة الله وبركاته.
في البداية، نتقدم بأحر العزاء إلى جميع المؤمنين والمسلمين والمحبين والموالين في مشارق الأرض ومغاربها في هذه الأيام الأليمة؛ الأليمة على قلب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، الأليمة على قلب فاطمة الزهراء (عليها السلام)، الأيام التي تركت في جسد الأمة جرحًا لا يندمل حتى ظهور قائم آل محمد (عجل الله تعالى فرجه الشريف). نتقدم إلى جميع المحبين والموالين بأحر العزاء بهذه المناسبة الأليمة.
وعودًا على بدء إلى ما تفضلتم به أخي الكريم في سؤالك، أود أن أتوقف قبل الغوص في جزئيات الموضوع الذي نود أن نتحدث عنه. أود أن أتوقف عند مفردة ذكرتها في كلامك: (الثورة). هذه المفردة، كلمة "الثورة" التي نستعملها ويستعملها الكثيرون في حياتنا في مجتمعاتنا عندما يتحدثون عن كربلاء، يصفونها بثورة كربلاء، ثورة الإمام الحسين في كربلاء، إلى آخره. أريد أن أتوقف هنا عند هذه المفردة لتصحيحها.
في واقع الحال، هذه المفردة لو أردنا أن ندقق بمدلولها اللغوي، وبشكل أدق بمدلولها الاجتماعي، نجد استعمال كلمة "الثورة" لو أردنا أن ننظر إليها بواقع علم الاجتماع، بواقع المصطلحات الحديثة لهذه الكلمة، لوجدنا أنها عبارة حديثة ترتبط بذكر الحسين (عليه السلام). فلو رجعنا إلى ما كُتب في التاريخ منذ القِدَم، منذ حركة الإمام الحسين (عليه السلام)، نهضة الإمام الحسين، لما وجدنا استعمالاً لهذه الكلمة. استعمال هذه الكلمة يعود في الثقافة الحديثة إلى القرن السابع عشر ميلادي، وهو الذي يرتبط بما أُطلق عليه الثورة الفرنسية. منذ ذاك الحين بدأ استعمال كلمة "الثورة" على عدد من الأشياء التي لها معنى حقيقي، واستُعملت بمعانٍ مجازية أخرى.
هنا أريد أن أتوقف عند هذا المصطلح لنتساءل، بعد أن نبين مدلول هذا المصطلح، هل هذا فعلاً ينطبق على ما نصف به حركة الإمام الحسين، أم لا؟ لو تأملنا كما قلت بهذا المصطلح، نجد أن هناك عدة تعاريف للثورة في هذه العصور المتأخرة، محورها -نلخصها لأنها ليست هي مادة الموضوع- أنها تطلق على الحراك الذي يقوم به الناس، الحراك الشعبي الذي يهدف إلى تغيير نظام الحكم، وبالتالي الاستيلاء على الحكم. صار في تعاريف متأخرة لها ما يعني دخول النخب، نخب المجتمع، القوات المسلحة وغيرها.
إذًا باختصار، نجد أن مصطلح "الثورة" يُطلق على جماعة تتحرك بهدف تغيير نظام الحكم القائم، وهو ما حصل بالثورة الفرنسية التي أطاحت بالعهد الملكي وأسست لسلسلة من العهد الجمهوري كما نعرف في التاريخ الحديث. ولذا نجد أنه بعد هذه المرحلة، الشعوب في كثير من البلدان عندما بدأت تتحرك لتغيير نظام حكم معين صار يُطلق عليها ذلك، لذا أُطلق فيما بعد مثلاً على الثورة التي حصلت في روسيا "الثورة البلشفية"، والثورة الفلانية، والثورة الجزائرية، وهكذا الدول التي حصلت فيها مثل تلك الحركات التي كانت تهدف إلى تغيير هذا الواقع.
هذا الكلام نطرح من خلاله سؤالًا: ونحن نجد أيضًا أنه بدأت تُستعمل كلمة "الثورة" بمصطلحاتنا الحديثة للإشارة إلى تغيير ما في نمط حياة الناس غير النظام السياسي، فنقول مثلاً: "ثورة تكنولوجيا المعلومات"، "الثورة الصناعية" التي غيرت واقعًا معينًا. كل هذه الاستعمالات، سواء كان استعمالها الأول الذي يرتبط بالثورة لتغيير الحكم، أو بما صارت تُستعمل فيه من صناعية وغيرها، لو أردنا أن نقف بمقابل ما يجسده الإمام الحسين (عليه السلام)، هل يصح حينئذ أن نقول إن ما قام به الإمام الحسين (عليه السلام) هو عنوان ثورة من أجل تغيير واقع حكم معين، أم أن المسألة أبعد بكثير وأعمق بكثير؟
لهذا السبب، أقول إنني أتحفظ، مع أننا أحيانًا نستعملها نتيجة تأثر ثقافتنا العامة بالمصطلح العام الذي تستعمله الناس في هذا الواقع. أقول أتحفظ عند هذا الاستعمال، لأن ما يمثله الحسين (عليه السلام) وما تجسده كربلاء هو أكبر بكثير من أن يوصف بمصطلح صغير مثل عنوان "ثورة" أو مثل عناوين أخرى يمكن أن تطلق عليها. لذا نقول: عاشوراء، كربلاء، لها عمق ولها أبعاد لا يمكن لأي عبارة أن تفيها حقها، ولذا نقول لا يمكن أن نعرّف عاشوراء إلا بكلمة "عاشوراء". وبالتالي، كربلاء تجسد حالة تتكامل فيها مجموعة من القضايا ذات البعد العقائدي، وذات البعد العاطفي، وذات البعد الاجتماعي، التي تهدف إلى رسم واقع معين يرتبط بمشروع السماء على الأرض. وعندما تكون كل هذه الأبعاد مرتبطة بعاشوراء ومرتبطة بالحسين (عليه السلام)، إذًا لا بد حينئذ من أن نتأمل أمام أي وصف نصف به كربلاء وعاشوراء.
المُقدِّم: أحسنتم. وهنا، نأتي إلى الجانب الآخر الذي مر في كلامكم. لو سمحتم، نحن ندخل في صلب الموضوع. تفضلتم بملاحظة جديرة بالاهتمام عن هذا المصطلح، مصطلح "الثورة"، ويمكن أن نعبر عنها بالملحمة الحسينية وما شابه ذلك، أو النهضة الحسينية، الحركة الحسينية. على كل حال، هناك لهذه الحركة العظيمة الرسالية التي تمتد شرعيتها من رسالة نبينا محمد (صلوات الله وسلامه عليه) وهو جد الإمام الحسين (عليه السلام)، فحبذا لو تفصلون وتشرحون عن موضوع أساسي: القائد في هذه الحركة لديه شروط، وكذلك المقتدي الذي يقتدي بهذا القائد.
فضيلة الشيخ: لا شك ولا ريب. يعني الآن مرت أكثر من مفردة في كلامك وكل واحدة منها عندما نريد أن نضيء عليها تأخذنا بالكلام نحو نافذة واسعة في الموضوع. نستطيع أن نقول إن ما يرتبط بالإمام الحسين (عليه السلام)، بحركة الإمام الحسين (عليه السلام)، بنهضة الإمام الحسين (عليه السلام)، هي حالة استثنائية فريدة من نوعها أرادتها السماء أن تكون على يد الحسين (عليه السلام) في كربلاء يوم عاشوراء.
وبالتالي، يرتبط هذا الموضوع بالمشروع الإلهي على الأرض الذي من أجله خلق الله تعالى الإنسان وبعث الأنبياء والرسل، وسارت الناس على هديهم في مواجهة من كان ضدهم منذ أبينا آدم وصولاً إلى نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). فكانت حركة الحسين (عليه السلام) محطة فاصلة تفصل بين تاريخ ما قبل الحسين (عليه السلام) وتاريخ ما بعد الحسين (عليه السلام). هذا التاريخ الذي يجسده الحسين (عليه السلام) بملحمته الخالدة التي نراها تعيش في النفوس وتنمو عامًا بعد عام، ولها أثر في كل القلوب وفي كل العقول وفي كل الأفئدة، نراها ترتبط بذاك البعد الذي من أجله كانت حركة الحسين (عليه السلام) في كربلاء ونهضته، وصولاً إلى استشهاده.
هنا قد يُطرح السؤال: كيف يكون الربط بين ذاك الموقع ما قبل عاشوراء وما بعد عاشوراء، وأثره على البعد العقائدي، وبالتالي على موقعية الحسين (عليه السلام) كمُقتدًى به، وعلينا نحن الذين نقول إننا نريد أن نقتدي بالحسين (عليه السلام)؟ في هذا المقام، نتوقف عند مفردة نعود فيها إلى عمق تاريخ البشرية. نحن نقرأ في القرآن الكريم أن الله تعالى عندما خلق الإنسان خلقه لهدف، وأنزل آدم إلى الأرض لهدف، وقال:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
إذًا هناك هدف من خلقة الإنسان على وجه هذه الأرض. هذا الهدف الذي أراده الله تعالى ضمن مسار سارت عليه البشرية ارتبط بميزة منحها الله تعالى لهذا الإنسان على هذه البسيطة، ألا وهي الاختيار. الإنسان مخلوق مختار في هذه الحياة، يختار ما يقوم به سواء كان منسجمًا مع ما يريده الله تعالى أو مخالفًا، فجعله خليفة. لذا الميزة التي امتاز بها الإنسان عن بقية المخلوقات أنه إنسان مخيّر في حياته. لهذا السبب، نجد أن الإنسان الذي يستقيم هو في مرتبة أعلى من مرتبة الملائكة، مع أن الملائكة مخلوقات مكرمة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الميزة أن الإنسان عندما يكون ملتزمًا، يكون ملتزمًا عن اختيار، أما الملائكة فهم يعبدون الله تعالى مجبولون على ذلك. وبالمقابل، نجد أن هناك مخلوقات أخرى لا تكليف لها، لم تُمنح العقل، لم تُمنح التكليف الذي أُعطي للإنسان، ألا وهي بقية الحيوانات. لهذا السبب، نجد أن الإنسان الذي يستقيم هو أرقى من الملائكة، وإذا انحرف فهو أسوأ من تلك الحيوانات.
المُقدِّم: لو سمحتم فضيلة الشيخ، نشكركم إلى هنا. نأخذ فاصلًا، أحبتي المشاهدين، للحديث تتمة بعد فاصل قصير.
المُقدِّم: السادة والسيدات، نرحب بكم مجددًا في برنامجكم "على خُطى الحسين (عليه السلام)". كنا مع فضيلة الشيخ نتحدث عن بداية قضية حركة الإمام الحسين (عليه السلام) وربطناها بهدف الخلقة من وراء ذلك، ونريد أن نربط هذا الموضوع بحركة الإمام الحسين (عليه السلام)، ونستطيع أن نقول نهضته (عليه السلام). وهناك تعبير جميل في كلام سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) يقول:
"من كان باذلاً فينا مهجته، وموطّنًا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحًا إن شاء الله تعالى."
هنا يؤسس الإمام الحسين (عليه السلام) حيثيات اللحوق والاقتداء به، وبعبارة أخرى، التأسيس لحيثيات المقتدي. هنا نود أن نشير إلى شروط المقتدي من حيث ما بدأتم به عن حكمة الخلقة وفلسفة الخلقة وهدفها.
فضيلة الشيخ: نعم، كلام الإمام الحسين (عليه السلام) الذي ذكرتموه يدخل في إطار بيان الموقعية الإلهية للإمام الحسين (عليه السلام) ضمن حركته في كربلاء. قبل الفاصل أشرنا إلى أن ما يرتبط بالحسين (عليه السلام) هو تاريخ يفصل ما قبله عما بعده. وما قبله يبدأ منذ آدم والهدف من الخلقة، حيث إن الله تعالى منح الإنسان ما لم يمنحه لأي من المخلوقات الأخرى وقال:
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
هنا ضمن هذا المشروع الإلهي على الأرض، نجد أن الله تعالى بعث لهذا الخلق مئة وأربعة وعشرين ألف نبي. مهمة الأنبياء أن يدلوا الناس على المشروع الإلهي على الأرض، ويدعوهم لاتباعه عن اختيار:
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ
وبالتالي لكي لا يكون للناس على الله حجة، فبعث الله تعالى الرسل، وكان آخر الأنبياء نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). هنا نتوقف عند مسألة: نجد أن دور الأنبياء عبر الزمن كان يتجسد بأن كل نبي من الأنبياء عندما يأتي بمهمته ويعاني ما يعاني ويواجه ما يواجه إلى أن يحقق الغرض، عندما يحقق الغرض تبدأ المواجهة بأسلوب آخر، فيحصل الانحراف في أمته. النبي في مهمته الأولى يدعو الناس للإيمان بالله تعالى، لا يقاتل أناسًا يؤمنون بالله ولهم انحرافات، بل يواجه من لا يؤمن بالله. عندما ينتصر عليهم ويحقق الغرض، وإذ بالانحراف يحصل في أمته. فنجدها تنحرف عما يوصي به، وهكذا نجد عبر سلسلة الأنبياء، النبي موسى (عليه السلام) غاب عنهم أيامًا فعبدوا العجل، وهكذا عيسى (عليه السلام) قالوا عنه إنه هو الإله، وهكذا سلسلة الأنبياء.
عندما يحصل الانحراف بعد كل نبي، كانت الإرادة الإلهية تبعث نبيًا آخر ليصحح مسار الأمة عبر الزمن. فكانت هكذا السلسلة وصولًا إلى نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) على منهج الرسل السابقين، وما سيحل بهذه الأمة هو ما حل في الأمم السابقة لهم. سرعان ما حصل الانحراف، ونموذج الانحراف الأكبر نجده عندما وصل إلى سدة السلطة في ذاك الوقت رجل مثل يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، فصار يتكلم في الأمة باسم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويصعد على منبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
هنا نجد أن مسار التاريخ توقف عند حدث اتصف به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، عند صفة اتصف بها النبي ألا وهو أنه النبي الخاتم. لن يبعث الله بعد محمد نبيًا على الإطلاق، وبالتالي، فالانحراف في أمته حصل كما حصل في الأمم السابقة. إذًا المشروع الإلهي على الأرض الذي يجسده الأنبياء من آدم إلى محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أصبح في مهب الريح فيما لو تجذرت سلطة يزيد بن معاوية وأصبح هو المجسد لحقيقة الإسلام، وحينئذ لحصل الانحراف الرسمي التام في هذه الرسالة ولانهزم المشروع الإلهي على الأرض.
الحسين (عليه السلام) كان هو الخط الفاصل بين هذين التاريخين، ليرسم منهجية تبقي المشروع الإلهي حيًا في هذه الأرض، ولكن على خلاف المنهجية السابقة عندما كان الله تعالى يبعث نبيًا في كل أمة ليصحح المسار بعد انحراف الناس عن النبي السابق. فرسم الحسين (عليه السلام) بحركته هذا المنهج الذي أبقى الرسالة الإلهية خالدة بنصاعتها، بعيدة عن كل ما أريد لها أن تصل إليه. ولهذا تكلم بالكلام الذي ذكرتموه وقال غيره أيضًا عندما قرر الخروج نحو العراق في أيام الحج. وهنا نتوقف عند نفس هذا الحدث الذي جعل الإمام الحسين (عليه السلام) يخرج من مكة، والناس تتجه نحو عرفة تحرم تريد أن تصعد لتلبي في عرفة، وهو يحول حجه إلى عمرة مفردة، ينهي مناسكه ويتجه نحو العراق. لماذا؟ لأن هناك رسالة إلهية يريد أن يؤديها الإمام الحسين (عليه السلام).
المُقدِّم: لو سمحتم، نعود إلى أصل الحديث في موضوع هذا القائد الفذ العظيم الذي جسد كما تفضلتم الرسالة الإلهية والمشروع الإلهي. فهناك الشروط لهذا القائد وكذلك للمقتدي به.
فضيلة الشيخ: لا شك. هنا عندما نريد أن نتحدث عن القدوة، يعني الحسين (عليه السلام) هو القدوة. وعندما نقول قدوة، هناك من يقتدي. لا بد حينئذ لمن يقتدي أولًا أن تتحقق فيه بعض الشروط، ويبحث عن شروط ومواصفات في القدوة التي يُقتدى بها. هذه مسألة لا شك فيها. لنبدأ قبل أن نتحدث عن القدوة وصفاتها، لنتحدث عن الجانب الآخر: المقتدي، ربطًا بما تحدثنا عنه من هدف الخلقة وما مُيّز به الإنسان من كونه مختارًا في حياته الدنيا.
أنا في هذه الحياة، ما هو هدفي؟ كيف أريد أن أكون في هذه الحياة؟ نحن نجد مثلاً في نمط حياتنا الاجتماعية هناك اهتمامات للجانب الاجتماعي. الأب عندما يُرزق بأولاد يفكر كيف يعلمهم، كيف يعمل، كيف يحصل القوت، كيف يحصل الجانب المادي إلى آخره. هناك جانب أساسي يحكم كل تلك الأمور: أنا كيف أريد أن أنظر إلى نفسي في هذه الحياة؟ ما هو هدفي في الحياة؟ هل أنني أريد أن أجسد الإنسان الذي أراده الله تعالى هدفًا من خلقته، فأكون إنسانًا مطيعًا لله تعالى، أم لا، أريد أن أجسد في حياتي الإنسان المتمرد، الإنسان الذي يعبد نفسه، الإنسان الذي يرى إلهه هواه، ومصداقًا لما تقول الآية الكريمة:
أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ
أنا في حياتي من هو إلهي؟ هل هو نفسي أم الله الخالق العظيم؟ هنا تكون البداية. فالإنسان عليه أن يحدد منطلقه في موقعه في هذه الحياة، ماذا يريد أن يكون؟ هل يريد أن يكون ممن يعبد هواه، أم يريد أن يكون نموذجًا للإنسان الذي يجسد في عمله طاعة لله تعالى؟ هذا هو المقياس. إذا قلنا إنه يريد أن يكون من الصنف الأول، فلا قيمة لأن يكون مقتديًا بمن يجسد رسالة الله على الأرض. أما إن أردنا أن نكون ممن يجسد العبودية الحقة لله تعالى، حينئذ لا بد من أن يبحث عمن جعله الله تعالى قدوة، ويتعرف على صفاته، ويعرف بأي جانب يقتدي به، ويعرف بأي حدود يقترب منه، لكي يكون حينئذ من مصاديق من يجسدون الطاعة الحقيقية لله تعالى في هذه الحياة.
المُقدِّم: أحسنت. فكما في الآية المباركة "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"، هذا المشروع الإلهي الرسالي يتجسد ويتحقق كذلك في الإمام الحسين (عليه السلام) بمثابة قائد. فالذي يريد أن يتبع الإمام الحسين (عليه السلام) لا بد وأن يكون مؤمنًا بما يجسده الإمام الحسين (عليه السلام)، بالدور الإلهي الذي يمثله، وباستعداده لكي يكون عبدًا صالحًا في حياته.
فضيلة الشيخ: أحسنتم. هذا جانب يعكس لنا صورة من الصفات التي لا بد وأن يلحظها الإنسان الذي يريد أن يتخذ الحسين قدوة في حياته. إذا وصلنا إلى هذه النقطة وحددنا الخلفية التي ننطلق منها، حينئذ علينا أن نبحث بالجانب الآخر: من الذي يجسد لنا في واقع حياتنا الأنموذج القدوة الذي علينا أن نقتدي به؟ في زمن الأنبياء كان الأمر واضحًا، كان الله يبعث نبيًا ويأمر الناس ويعطيهم الأدلة فيتبعونه. هنا الحسين (عليه السلام) رسم منهجًا، فهو حامل منظومة النبوة وهو وارث منظومة الأنبياء جميعًا. لا بد من أن نبحث حينئذ عن الصفات والمؤهلات، وبالتالي عن دورنا في متابعة هذه المسيرة، إلى أين يمكن أن نصل؟ وإلى أين يمكن أن نقترب من الحسين (عليه السلام)؟
المُقدِّم: لكم جزيل الشكر فضيلة الشيخ على هذا الإيضاح البين والقيّم. نصل إلى ختام هذه الحلقة أحبتي المشاهدين. شكرًا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ونتمنى أن نلقاكم في حلقات قادمة في برنامجكم "على خُطى الحسين (عليه السلام)". قد بدأنا مشروع الخُطى العقائدية والشرعية في بداية هذا البرنامج وفي حلقاته الأولى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.